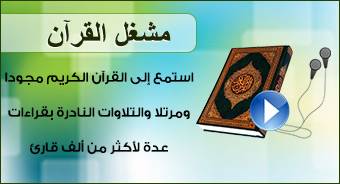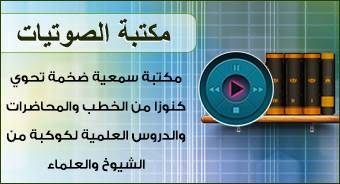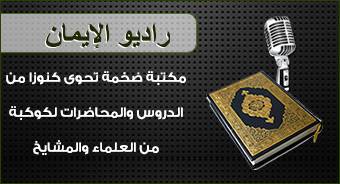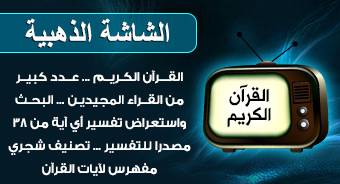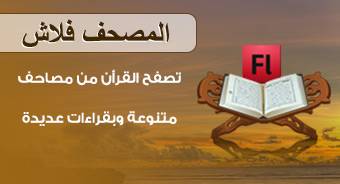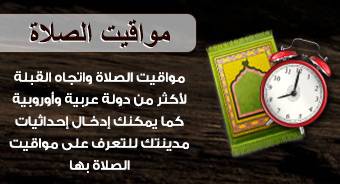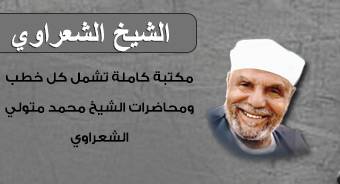|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
فهذا كله حقّ لا امتراء فيه، وهو واقع كما أخبر به الحقّ جلّ وعلا، على سبيل القطع واليقين..وقوله تعالى: {مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقا لصفة محذوفة أيضا لخبر إن، والمقام دالّ على هذين المحذوفين والتقدير:فورب السماء والأرض إن ذلك كله لحق واقع وقوعا مماثلا لوجودكم الذي أنتم عليه، والذي لا يمكن أن تنكروه.. وهل ينكر الإنسان وجوده، وهو حى ناطق؟واختيار النطق صفة دالة على وجود الإنسان، لأن المنطق هو الصفة المميزة للإنسان عن عالم الحيوان، ولأن النطق كذلك يدلّ على أن وراءه إنسانا ذا حس وإدراك، وأنه إذا غابت عنه المحسات والمدركات، فلن يغيب عنه الإحساس بوجوده، وإدراك أنه موجود..أخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «قاتل اللّه قوما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدّقوا» وروى عن الأصمعى أنه قال: أقبلت من جامع البصرة، فطلع أعرابى على قعود، فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بنى أصمع، قال: من أين أقبلت، قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال: اتل علىّ، فتلوت (والذاريات) فلما بلغت {وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ} قال: حسبك.. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسر هما، وولىّ..يقول الأصمعى: فلما حججت مع الرشيد، طفقت أطوف، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفتّ، فإذا بالأعرابى قد نحل واصفرّ، فسلّم علىّ، واستقرأنى السورة، فلما بلغت الآية: {وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ}.صاح، وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّا.. ثم قال: وهل غير هذا؟فقرأت: {فَوَرَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} فصاح وقال: يا سبحان اللّه، من ذا أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدّقوه يقوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثا، وخرجت معها نفسه!!. اهـ.
الخامس: المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يُهجَهُه الهاجع.وانتصب {قليلًا} على الظرف لأنه وُصف بالزمان بقوله: {من الليل}.والتقدير: زمنًا قليلًا من الليل، والعامل في الظرف {يَهجعون}.و{من الليل} تبعيض.ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر، أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله أن يغفر لهم بعد أن قدّموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى الله تعالى.وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر.فأما في السحر فهم يتهجدون، ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر.وهذا نظير قوله تعالى: {والمستغفرين بالأسحار} [آل عمران: 17]، وليس المقصود طلب الغفران بمجرد اللسان ولو كان المستغفر في مضجعه إذ لا تظهر حينئذٍ مزية لتقييد الاستغفار بالكون في الأسحار.والأسحار: جمع سحر وهو آخر الليل.وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخرى.وجَمْع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر.وتقديم {بالأسحار} على {يستغفرون} للاهتمام به كما علمت.وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند إليه دُون ضميره لقصد إظهار الاعتناء بهم وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي فيفيد تقوّي الخبر لأنه من الندّرة بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشقّ على من يقوم الليل لأن ذلك وقت إعيائه.فهذا الإسناد على طريقة قولهم: هو يعطي الجزيل.وحق السائل والمحروم: هو النصيب الذي يعطُونه إياهما، أطلق عليه لفظ الحق، إمّا لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسَّر قبل أن يفرض عليهم الزكاة فإن الزكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم، أو لأنهم ألزموا ذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم.وبذلك يتأوَّل قول من قال: إن هذا الحق هو الزكاة.والسائل: الفقير المظهر فقره فهو يسأل الناس، والمحروم: الفقير الذي لا يُعطَى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر، وهو الصنف الذي قال الله تعالى في شأنهم {يحسبهم الجاهلُ أغنياء من التعفّف} [البقرة: 273] وقال النبي صلى الله عليه وسلم «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافًا».وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة لأنه لم يَسأل الناس ويحرموه ولكن لما كان مآل أمره إلى ما يؤول إليه أمر المحروم أطلق عليه لفظ المحروم تشبيهًا به في أنه لا تصل إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه فكأنه ناله حرمان.والمقصود من هذه الاستعارة ترقيق النفوس عليه وحثّ الناس على البحث عنه ليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها فيه ونظيرها في سورة المعارج.قال ابن عطية: واختلف الناس في {المحروم} اختلافًا هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالًا.قلت ذكر القرطبي أحد عشر قولا كلها أمثلة لمعنى الحرمان، وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثالًا للغرض قُبل وما لم يصلح فهو مردود، مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب.وفي (تفسير ابن عطية) عن الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم.وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي قال: لي اليوم سبعون سنة منذ احتملت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذٍ.{وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)}.هذا متصل بالقَسَم وجوابه من قوله: {والذاريات} [الذاريات: 1] وقوله: {وإن الدين لواقع} إلى قوله: {والسماء ذات الحبك} [الذاريات: 6، 7] فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده بالقسم انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه، فيكون هذا الاستدلال كقوله: {ومن آياته أنك تَرى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربَتْ إن الذي أحياها لمُحيي الموتى} [فصلت: 39].وما بين هاتين الجملتين اعتراض، فجملة {وفي الأرض آيات للموقنين} يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي {إن ما تُوعدون لصادق} [الذاريات: 5].والمعنى: وفي ما يشاهد من أحوال الأرض آيات للموقنين وهي الأحوال الدالة على إيجاد موجودات بعد إعدام أمثالها وأصولها مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن بَاد الذي قبله وصار هشيمًا.وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر فلذلك لم تقرن هذه الآيات بما يدعو إلى التفكر كما قرن قوله: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون} [الذاريات: 21].واعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة أيضًا على تفرده تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحْوها للحيوان والإنسان، وكيف قسمت إلى سهل وجبال وبحر، ونظام إنباتها الزرع والشجر، وما يخرج من ذلك من منافع للناس، ولهذا حذف تقييد آيات بمتعلِّق ليعمّ كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه.وتقديم الخبر في قوله: {وفي الأرض} للاهتمام والتشويق إلى ذكر المبتدأ.واللام في {للموقنين} معلق بـ {آيات}.وخصت الآيات بـ {الموقنين} لأنهم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث.وأوثر وصف الموقنين هنا دون الذين أيقنوا لإفادة أنهم عرفوا بالإيقان.وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية.
|