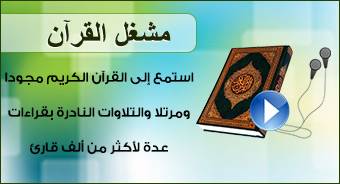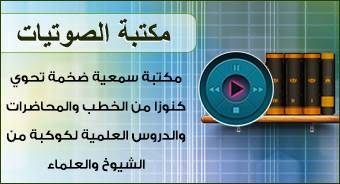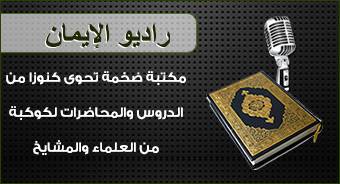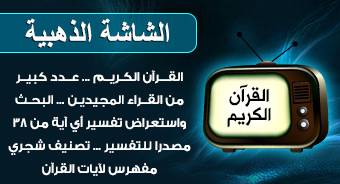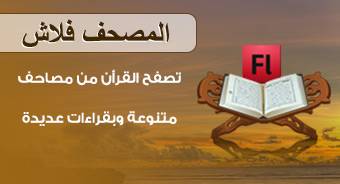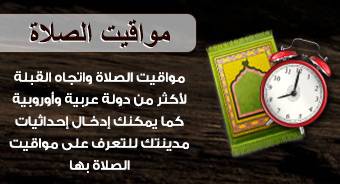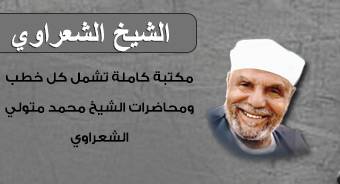|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقوله: {فَهُوَ يَهْدِينِ} جملةٌ اسميةٌ في محلِّ رفعٍ خبرًا له. قال الحوفي: ودَخَلَتِ الفاءُ لِما تَضَمَّنه المبتدأُ مِنْ معنى الشرط. وهذا مردودٌ؛ لأنَّ الموصولَ مُعَيَّنٌ ليس عامًَّا، ولأنَّ الصلةَ لا يمكنُ فيها التجدُّدُ، فلم يُشْبِهِ الشرطَ. وتابع أبو البقاء الحوفيَّ ولكنه لم يتعرَّضْ للفاء. فإنْ عنى ما عناه الحوفيُّ فقد تقدَّمَ ما فيه. وإن لم يَعْنِهِ فيكونُ تابعًا للأخفش في تجويزِه زيادةَ الفاءِ في الخبر مطلقًا نحو: زيدٌ فاضربه، وقد تقدَّم تحريرُه.{وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79)}.قوله: {والذي هُوَ يُطْعِمُنِي}: يجوز أن يكونَ مبتدًا، وخبرُه محذوفٌ. وكذلك ما بعده. ويجوزُ أَنْ يكونوا أوصافًا للذي خَلَقني. ودخولُ الواوِ جائزٌ. وقد تقدَّم تحقيقُه في أولِ البقرةِ كقوله:
وأثبت ابنُ أبي إسحاقَ وتُرْوى عن عاصم أيضًا ياءَ المتكلمِ في {يَسْقِينِ} و{يَشْفِينْ} و{يُحْيِيْنِ}. والعامَّةُ {خَطِيئَتي} بالإفرادِ. والحسن {خطاياي} جمعَ تكسيرٍ.{وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85)}.قوله: {مِن وَرَثَةِ}: إمَّا أَنْ يكونَ مفعولًا ثانيًا أي: مستقِرًَّا أو كائنًا مِنْ وَرَثَةِ، وإمَّا أَنْ يكونَ صفةً لمحذوفٍ هو المفعولُ الثاني، أي: وارِثًا مِنْ وَرَثَةِ.قوله: {يَوْمَ لاَ يَنفَعُ}: بدلٌ مِنْ {يوم} قبلَه. وجعل ابنُ عطيةَ هذا من كلامِ اللهِ تعالى. إلى آخر الآياتِ مع إعرابِه {يومَ لا ينفعُ} بدلًا مِنْ {يوم يُبْعَثون}. ورَدَّه الشيخُ: بأنَّ العامِلَ في البدلِ هو العامِلُ في المبدلِ منه، أو آخرُ مثلُه مقدَّرٌ. وعلى كِلا هذين القولَين لا يَصِحُّ لاختلافِ المتكلِّمين.قوله: {إِلاَّ مَنْ أَتَى الله}: فيه أوجهٌ، أحدُها: أنه منقطِعٌ أي: لكنْ مَنْ أتى اللهَ بقَلْبٍ سليمٍ فإنه ينفَعُه ذلك. وقال الزمخشري: ولابد لك مع ذلك مِنْ تقديرِ مضافٍ وهو الحالُ المرادُ بها السلامةُ، وليست من جنسِ المالِ والبنينَ، حتى يَئول المعنى إلى: أنَّ البنينَ والمالَ لا ينفعانِ، وإنما ينفعُ سَلامةُ القلبِ، ولو لم يُقَدَّرِ المُضافُ لم يَتَحصَّلْ للاستثناءِ معنى.قال الشيخ: ولا ضرورةَ تَدْعُو ألى حذفِ المضافِ كما ذكر. قلت: إنما قَدَّرَ المضافَ ليُتَوَهَّمَ دخولُ المستثنى في المستثنى منه؛ لأنه متى لم يُتَوَهَّمْ ذلك لم يَقعِ الاستثناءُ، ولهذا مَنَعوا: صَهَلَتِ الخيلُ إلاَّ الإِبِلَ إلاَّ بتأويلٍ.الثاني: أنه مفعولٌ به لقوله: {لا يَنْفَعُ} أي: لا ينفعُ المالُ والبنونَ إلاَّ هذا الشخصَ فإنه ينفَعُه فإنه ينفَعُه مالُه المصروفُ في وجوهِ البِرِّ، وبنوه الصلحاءُ، لأنه عَلَّمهم وأحسنَ إليهم. الثالث: أنه بدلٌ مِن المفعولِ المحذوفِ، أو مستثنى منه، إذ التقديرُ: لا ينفعُ مالٌ ولا بنونَ أحدًا من الناس إلاَّ مَنْ كانت هذه صفتَه. والمستثنى منه يُحْذَفُ كقوله:ولم يَنْجُ إلاَّ جَفْنَ سيفٍ ومِئْزرا *أي: ولم يَنْجُ بشيءٍ. الرابع: أنه بدلٌ مِنْ فاعلٍ {يَنْفَعُ} فيكون مرفوعًا. قال أبو البقاء: وغَلَّبَ مَنْ يَعْقِلُ فيكون التقديرُ: إلاَّ مالُ مَنْ، أو بنو مَنْ فإنه ينفع نفسَه وغيرَه بالشفاعة.قلت: وأبو البقاء خَلَط وجهًا بوجهٍ: وذلك أنه إذا أرَدْنا أن نجعلَه بدلًا من فاعل ينفع فلنا فيه طريقان، أحدهما: طريقةُ التغليب أي: غَلَّبْنا البنين على المالِ، فاستثنى من البنين، فكأنه قيل: لا ينفعُ البنونَ إلاَّ مَنْ أتى مِن البنين بقلبٍ سليم فإنه ينفع نفسَه بصلاحِه، وغيرَه بالشفاعةِ.والطريقة الثانية: أَنْ تُقَدِّر مضافًا محذوفًا قبل {مَنْ} أي: إلاَّ مالُ مَنْ أو بنو مَنْ فصارَتِ الأوجُه خمسةً.ووجَّه الزمخشريُّ اتصالَ الاستثناءِ، بوجهين، أحدُهما: إلاَّ حالَ مَنْ أتى اللهِ بقلبٍ سليمٍ، وهو مِنْ قوله: ومثاله أن يقال: هل لزيدٍ مالٌ وبنون؟ فيقال: مالُه وبَنُوه سلامةُ قلبِه. تريد نَفْيَ المالِ والبنين عنه، وإثباتَ سلامةِ قلبِه بدلًا عن ذلك. والثاني قال: وإن شِئْتَ حَمَلْتَ الكلامَ على المعنى وجَعَلْتَ المالَ والبنين في معنى الغنى، كأنه قيل: يومَ لا يَنْفع غِنَى إلاَّ غَنى مَنْ أتى، لأنَّ غِنى الرجلِ في دينِه بسلامةِ قلبِه، كما أنَّ غِناه في دنياه بمالِه وبنيه. اهـ.
ويقول آخر: ويقال ذلك الشفاءُ الذي أشار إليه الخليلُ هو أن يَبْعَثَ إليه جبريلَ ويقول له: يقول لَكَ مولاك كيف كنتَ البارحة؟.{وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81)}.أضاف الموتَ إلى الله؛ فالموتُ فوق المرض، لأن الموتَ لهم غنيمةٌ ونعمةٌ؛ إذ يَصِلُون إليه بأرواحهم.ويقال: {يُمِيتُنِى} بإعراضه عني وقت تعزُّزِه، {ويحييني} بإقباله عليَّ حين تَفَضُّلِه. ويقال يميتني عني ويحييني به.{وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82)}.خطيئةُ الأحبابِ شهودُهم محنتَهم، وتعنِّيهم عند شدة البلاء عليهم، وشكواهم مما يمُّسهم من برحاء الاشتياق، قال بعضهم:وإذا محاسني- اللاتي أُدِلُّ بها-... كانت ذنوبي، فَقُلْ لي: كيف أعتذر.{رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83)}.{هَبْ لِى حُكْمًا}: على نفسي، فإنَّ مَنْ لا حُكْمَ له على نفسه لا حَكْمَ له على غيره.{وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ}: فأقومَ بِحقِّكَ دونَ الرجوع إلى طلب الاستقلال بشيءٍ. دون حقك.{وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)}.في التفاسير: {لِسَانَ صِدْقٍ}: أي ثناء حسنًا على لسان أمة محمد صلى الله عليه وسلم.ويقال لا أذكرك إلا بك، ولا أعرفك إلا بك.ويقال أن أذكرك ببيان آلائك، وأذكرك بعد قبض روحي إلى الأبد بذكرٍ مُسرمَدٍ.ويقال أذكرني على لسان المخبرين عنك.{وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86)}.على لسان العلماء: قالَه بعد يأسه من إيمان أبيه، وأمَّا على لسان الإشارة فقد ذَكَرَه في وقت غَلَبَاتِ البَسْطِ ويُتَجَاوَزُ ذلك عنهم.وليست إجابةُ العبد واجبًا على الله في كل شيء، فإذا لم يُجَبْ فإنَّ للعبد سلوةً في ذكر أمثال هذا الخطاب، وهذا لا يهتدي إليه كلُّ أحدٍ.{وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87)} أي لا تُخْجِلْني بتذكيري خلَّتي، فإنّ شهودَ ما مِن العبد- عند أرباب القلوب وأصحاب الخصوص- أشَدُّ عقوبة.{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)}.قيل: القلب السليم اللديغ.وقيل هو الذي سَلِمَ من الضلالة ثم من البِدعة ثم من الغفلة ثم من الغيبة ثم من الحجبة ثم من المُضاجعة ثم من المساكنة ثم من الملاحظة. هذه كلها آفاتٌ، والأكابرُ سَلِمُوا منها، والأصاغرُ امتُحِنُوا بها.ويقال: القلب السليم الذي سَلِمَ من إرادة نَفْسِه. اهـ.
|